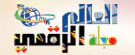|
| |
الديمقراطية والإرهاب(2 3)
عبدالله الصالح العثيمين
|
|
مما أشير إليه في الحلقة الأولى أن الأمة في مرحلة ضعفها تستهويها مبادئ الأمم القوية ومظاهر حياتها، وأن أمتنا بسبب ضعفها الراهن الآن وُجد بين مفكريها من أولعوا بالاشتراكية حين كانت مبادئها سائدة في الاتحاد السوفيتي السابق والصين. ولما فشلت في معقلها الأقوى شغف البعض بالحديث عن الديمقراطية وكأنها البلسم الشافي لجميع أمراض مجتمعاتها. ومما أشير إليه، أيضاً، بعض من أسس الديمقراطية وإيجابياتها وسلبياتها.
على أن حكم الشعب، الذي هو أساس الديمقراطية، فُسِّر بمعنى مختلف في الاتحاد السوفيتي السابق وفي الصين حيث اقتصر فيها على تكوين حزب واحد. ومنطلق المتبنّين لهذا التفسير أن هذا الحزب يمثّل العمال والفلاحين. وهؤلاء وأولئك هم - في الواقع - أكثرية سكانهما. وبما أن الديمقراطية تعني حكم الأكثرية فإنهم ديمقراطيون. ولهذا لم يكن غريباً أن سُمِّيت حكومة ألمانيا الشرقية - قبل إعادة وحدة الشعب الألماني أخيراً - ديمقراطية وإن اتّصفت بما اتصفت به من شمولية.
ومن المعلوم أن الشيوعية - بكل ما أضفى عليها المتحمِّسون لها سابقاً من أوصاف عرف الجميع فيما بعد أنها لم تكن منطبقة مع الواقع - قد سقطت في أهم معاقل تطبيقها؛ وهو الاتحاد السوفيتي، أو هي تحت مبضع الجراحة في آخر معاقلها الرئيسة؛ وهو الصين، لتصبح منسجمة بطريقةٍ ما مع أوضاع العالم المستجدة. والبوادر توحي بأن القائمين بهذه الجراحة - بحكمتهم المتوارثة - أمهر مما يتصوره الكثيرون.
ومع إيجابيات الديمقراطية الغربية، التي أشير إلى شيءٍ منها، فإن من ذوي الرأي والفكر في المجتمعات الغربية ذاتها من رأوا أنه لا بد من إعادة النظر فيها؛ منهجاً وتطبيقاً.
فروبرت دال - وهو منظر لامع في أمريكا - بيَّن في كتابه الديمقراطية ونُقَّادها، أن قاعدة الأغلبية، التي تقوم عليها الديمقراطية، لا تتحقَّق أحياناً على أرض الواقع، ورأى أن ديمقراطية الأجيال اللاحقة لن تكون بصيغة الأجيال السابقة. وبول كيندي - وهو مؤرخ مشهور - انتقد في كتابه: الاستعداد للقرن الحادي والعشرين الوضع الديمقراطي من حيث الخلل الحزبي وتأثير جماعات الضغط في العمل الانتخابي والسياسي. وألفن توفلر - وهو مفكر ذائع الصيت في أمريكا - يوضّح في كتابه: بناء حضارة جديدة أن النظام الديمقراطي تآكل، وأن دستور الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة نظر.
إن من أسس الديمقراطية الحرِّية؛ رأياً وتعبيراً، واحترام حقوق الإنسان، وتحميل من أخلّ بحقوق الأمة؛ معنوياً أو مادياً، مسؤولية إخلاله بتلك الحقوق، وإلزامه بتنفيذ تبعاتها. وقد يفقد بسبب ذلك الإخلال كل ما حققه من نجاح سياسي ومكانة اجتماعية. على أن المخلّ قد يفلت من العقوبة بمكره ودهائه، كما حدث أخيراً بالنسبة لمن كذبوا على الشعبين الأمريكي والبريطاني في قضية أسلحة الدمار الشامل، التي زعموا أن العراق كان يمتلكها قبل عدوانهم عليه، واحتلال أراضيه والسيطرة على مخازن تراثه ومقدّرات ثرواته.
والديمقراطية بمفهومها الغربي نتاج فكري غربي تمخَّض عن ظروف اجتماعية معيَّنة في العالم الغربي؛ وبخاصة في أوروبا. وما فيها من ثمار إيجابية - بينها المناداة بحقوق الإنسان والعدالة أمام القانون - جناها ذوو الأصول الأوروبية ومازالوا يجنونها بدرجة كبيرة. لكن ماذا عن تعامل ذوي تلك الأصول مع غيرهم من أصول أخرى؛ سواء داخل المجتمعات التي أصبحوا المهيمنين فيها أو خارج تلك المجتمعات من بلدان العالم؟
من يتأمَّل صفحات التاريخ، ويربط ما فيها بوقائع الحاضر المشاهد، يكد يصل إلى استنتاج مؤدَّاه أن ذوي الأصول الأوروبية، الذين لهم السبق في تبنّي النظم الديمقراطية، نظروا - وما فتئوا ينظرون - إلى غيرهم نظرة مشابهة للنظرة التي ذكر الله في محكم كتابه أن اليهود نظروها تجاه الآخرين؛ قائلين: (ليس علينا في الأميين سبيل). إنها نظرة الاستعلاء والفوقية. يقول توماس باترسون في كتابه ابتداع الحضارة الغربية (ترجمة شوقي جلال، ص21): (إن مصطلح الحضارة صيغ في أوروبا في سياق التوسع الاستعماري الأوروبي، وإنه جرى على ألسنة النخبة في الدول الغربية، واستهدفوا التمييز بين أنفسهم والشعوب التي التقوا بها. فما إن انتقلوا إلى ما وراء البحار حتى استخدموا التصنيفات الفئوية الشائعة حينذاك مثل: المتوحشين والهمج والكفار والبرابرة، وعاملوا الشعوب الأخرى كما لو لم يكونوا بشراً، وارتكبوا لذلك ضد هذه الشعوب فظاعات وحشية).
وإذا كانت نظرة الأمريكيين المنحدرين من أصل أوروبي إلى الآخرين نظرة استعلاء وفوقية فإن نظرتهم إلى العرب بالذات في منتهى الظلم. فمثلاً أجري استطلاع عام 1980 م؛ أي قبل حادثة 11 سبتمبر بواحد وعشرين عاماً، عن الصورة النمطية للعربي المسلم فظهر أن النسبة: بربري قاس وعنيف 44%، خائن ومكاَّر 49%، متعطِّش للدم 50%، معاد للنصرانية والسامية 40%، (كاثرين بولوك، إعادة التفكير عن المرأة المسلمة والحجاب، أمريكا 2003، ص227).
ولذلك لم يمنع تبنِّي المجتمعات الغربية الديمقراطية، التي من أسسها المناداة بحقوق الإنسان والعدل كما سبق أن ذكر، بعض دولها من ممارسة العدوانية والظلم للآخرين. وما ارتكبه ذوو الأصول الأوروبية تجاه السكان الأصليين في أمريكا من جرائم عندما حلَّوا بأرضها مغتصبين لها شاهد على تلك العدوانية وذلك الظلم. ثم ما مورس ضد الملوَّنين فيها؛ وبخاصة السود، من تمييز عنصري لم يلغ رسمياً. إلا عام 1964م عندما صدر في أمريكا قانون الحقوق
المدنية، شاهد آخر على ترسُّخ الشعور بالاستعلاء والفوقية في نفوسهم.
وإذا كان ذلك قد حدث في الأرض التي اغتصبها ذوو تلك الأصول، وأصبحوا المهيمنين فيها فإنه لم يكن غريباً أن قامت دول أوروبية تبنَّت الديمقراطية في أراضيها بالعدوان على أقطار أخرى، واستعمارها، والتنكيل بأهلها. ومن المعلوم - مثلاً - ما ارتكبت بريطانيا، أولى الدول الأوروبية التي تطوَّرت فيها الديمقراطية الغربية، في مناطق متعددة من العالم؛ احتلالاً لأراضيها، وتنكيلاً بأهلها، ونهباً لثرواتها. ومن المعلوم، أيضاً، ما ارتكبته فرنسا، التي نادت ثورتها المشهورة بالحرِّية والمساواة، من عدوان على شعوب كثيرة، وانتهاك لحقوقها، ومحاولات لطمس هويتها الوطنية.
واحترام حقوق الإنسان، المبدأ العظيم من مبادئ الديمقراطية، هل راعته بريطانيا - مثلاً - عندما تآمرت مع فرنسا على تقسيم الأراضي العربية، التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية؛ خائنة بذلك وعدها للحسين بن علي -رحمه الله-، بأن يكون ملكاً على تلك الأراضي بعد انتزاعها من العثمانيين؟ وهل راعت تلك الحقوق عندما اؤتمنت منتدبة على فلسطين؟ ألم تساعد الصهاينة على إعداد أنفسهم للسيطرة عليها في آخر الأمر؛ تنفيذاً لوعد بلفور لهم بالعمل على قيام وطن قومي لهم فيها؟ ومن المعروف أن أول من عيَّنته مندوباً سامياً لها فيه كان يهودياً. على أن من المسيحيين المتصهينين من لا يقلّون عداوة للعرب والمسلمين من الصهاينة أنفسهم.
وماذا عن الحرِّية في دولة الثورة التي كانت الحرِّية إحدى الركائز المنادى بها؟ إن صفحات تاريخ فرنسا الاستعماري مليئة بالجور؛ بل إن الاستعمار بحدِّ ذاته اعتداء على حرِّية الآخرين. ولقد اتَّخذ حكام فرنسا في الآونة الأخيرة من المواقف ما يدلُّ على أنهم لا يقيمون وزناً للحرِّية أو الديمقراطية. ومن ذلك أن الرئيس الفرنسي السابق، ميتران، حذَّر - أيام الانتخابات الحرَّة التي أجريت في الجزائر - بأنه سيتدخَّل عسكرياً ضدها إن وصل إلى حكمها أصحاب التوجه الإسلامي، وإن يكن ذلك الوصول عبر انتخابات حرَّة. ومن ذلك، أيضاً، أن أحد الباحثين الفرنسيين كتب رسالة علمية شكَّك فيها - حسب الوثائق - في عددٍ من ادُّعي قتلهم من اليهود على أيدي النازيين، وأجازت الجامعة التي كتبت فيها تلك الرسالة بحث ذلك الباحث. لكن بعد شهر تقريباً قدم وزير التعليم الفرنسي نفسه إلى الجامعة، وعنَّفها على إجازتها الرسالة، وسحبت الشهادة التي أعطيت لكاتبها.
وماذا عن أمريكا، التي أصبحت لها الهيمنة شبه التامة على أكثر مجريات الحوادث في العالم؟
لقد كتب بيرنارد لويس، المستشرق الصهيوني، الذي أصبح الآن بمثابة المرشد العام لجماعة المتصهينين المتولّيين مقاليد الأمور في أمريكا، سلسلة مقالات محاولاً إظهار وجوه شبه بين نشأة أمريكا والدولة الصهيونية في فلسطين؛ وذلك بهدف ترسيخ مشاعر الودّ تجاه
الكيان الصهيوني. لكنه لم يشر إلى مسألتين مهمتين:
الأولى: إن طلائع الأوروبيين المستعمرين لأمريكا كانوا متصهينين فكراً. بل إن الحاخام المؤرخ لي ليفنجر ذكر أنهم كانوا أكثر يهودية من اليهود. ولذلك لم يكن غريباً أن أطلقوا على بعض مستوطناتهم وأبنائهم أسماء عبرية، وسمَّوا البلاد التي احتلُّوها أرض الميعاد، أو أرض إسرائيل الجديدة. ومما تجدر الإشارة إليه أن عنوان أول أطروحة للدكتوراه في جامعة هارفرد، سنة 1642 م، كان العبرية هي اللغة الأم، وأن الرئيس الأمريكي، جون آدمز، دعا، سنة 1818م إلى إقامة حكومة يهودية مستقلة في فلسطين، وأنه في عام 1831 م قال جورج بوش - ولعلّه جد للرئيس الأمريكي الحالي - في كتابه: حياة محمد مؤسس دين الإسلام: (ما لم يتم تدمير امبراطورية السارزن (يعني المسلمين على سبيل الاحتقار) فلن يتمجَّد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم).
الثانية: إن قيام دولة أمريكا قد ارتكبت فيه حرب إبادة بشعة ضد السكان الأصليين، الذين سُمُّوا الهنود الحمر كما أشير إليه سابقاً، وقيام الكيان الصهيوني في فلسطين ارتكبت فيه مجازر شنيعة ضد أهل البلاد من الفلسطينيين لإرعابهم، ومن ثمَّ اضطرارهم إلى مغادرة وطنهم.
وإذا كان الرئيس الأمريكي آدمز قد دعا، سنة 1818م إلى إقامة حكومة يهودية مستقلة في فلسطين فهل يستغرب ان كان الرئيس ولسون أول زعيم غربي يؤيِّد، عام 1918م؛ أي بعد مئة سنة من تلك الدعوة، وعد بلفور المشؤوم؟ وكون ذلك التأييد يتنافى مع ما نادى به الرئيس ولسون نفسه من مبادئ عظيمة لا يستغرب من دولة اشتهر زعماؤها بازدواجية المعايير. أما ما حدث من تولِّي ترومان الرئاسة الأمريكية حتى الآن من دعم أمريكي للصهاينة؛ سياسياً وعسكرياً ومالياً، فأمر لا يخفى.
|
|
|
| |
|