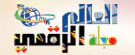|
| |
قراءة في كتاب (موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو) للسيد البحراوي
شوق محمد عبدالحميد
| | الرقص والموسيقى والشعر ثلاثة فنون كان منبعها الحركة الإيقاعية - جسدية كانت أم شفهية - الصادرة عن الأجسام البشرية المندرجة في العمل الجماعي. فالإنسان - كما هو معلوم - كائن مخلوق تتكاتفه الهموم والأحزان فلا يملك إلا أن يترجمها بزفرات تريح جسمه المكدود وتنفس عنه آلام قلبه المكلوم، وكانت هذه الزفرات قد صاحبت عمل الإنسان البدائي منذ القدم الذي كان من المشقة القيام به فبحث وفتش في مكنونه عما يسليه ويبهجه ويذهب عنه طول عنائه في العمل ففطن لدقات قلبه المنتظمة ذات الإيقاع اللافت والجاذب للسمع والقادرة على تنظيم عمل وظائف الجسم والمساعدة في إنجاز ذلك بأسرع وقت من خلال إيقاعها المنتظم وكأنه فطن لقول الشاعر أحمد شوقي:
دقات قلب المرء قائلة إن الحياة دقائق وثواني
فأخذ شيئاً فشيئاً يتراقص بجسده تحت إيقاعات خفية باطنية لا يراها ولا يعرف كنهها إلى أن تلفظ بها بإيقاعات تناسب طبيعة عمله سواء من حيث الخفة أو الرزانة، فأخذ يسلي نفسه بها ويذهب عنه عناء يومه.
كما أن العربي القديم فطن لجدوى هذه الموسيقى الموقعة بألحانها الخفيفة السلسة فاستخدمها ورنم بها إبله في مسيره وإياها وهو إيقاع جميل يعرف بالحداء، إذاً فالموسيقى كانت وما زالت من أهم العناصر التي تساعد في سير نمط الحياة بصورة مريحة ومعينة على تجنب جزء من الشقاء الملازم للإنسان في حياته - أقصد الموسيقى الشعرية - هذا ما خلصت إليه من فائدة في مدخل هذا الكتاب عن موسيقى الشعر. وقد تناول الباحث قضايا عديدة، منها الفارق بين الشعر والنثر من حيث الإيقاع الصوتي وتنوعه في اللغة فالشاعر دائم البحث عن لغة جديدة يضعها في نسق جديد.. يتميز بالانتظام والموسيقى.. بلغة أكثر كثافةً وتعقيداً وشكليةً.. كون التجربة الشعرية أعمق وأخصب وأكثر كثافة وتعقيداً.. وهي بالتأكيد تختلف عن التجربة النثرية.
كما أن هناك ثمة فارق بين مصطلحي الوزن والإيقاع عرضها بشكل مفيد هو خلاصة الكلام - كما يقال- إذاً فهو قد تعرض للنواحي الفنية التي تتعلق بالشكل الهيكلي للقصيدة وما تحتويه من وزن وإيقاع مروراً بالزحافات والعلل - التي تشكل وظيفة فنية لها دور أساسي في زيادة جرعة الإيقاع الموسيقي داخل النص أكثر مما كونها عيوباً عند الناقد العربي القديم - سيراً إلى القافية ودورها في تشكيل ظاهرة التجانس مع الصوائت التي تعطي إحساساً بالامتداد والهدوء كما أنها - أي الصوائت - تعتبر الأساس لعنصر اللحن في موسيقى الشعر... فهي تلحق بالكلام المشعور إذا أريد به الحداء والترنم.. كما أن الباحث تعرض في كتابه لقضية العلاقة بين الظواهر الصوتية ومدلولاتها وكيف أنها أصبحت تخضع لحكم انطباعي ذاتي وذلك لغياب القاعدة العلمية الصحيحة التي تثبت مثل هذه العلاقة، وقد تعرض الباحث أيضاً لقضية جوهرية وهي العلاقة بين المعنى والإيقاع، فالإيقاع يضيف للمعنى بظلاله ويوحي بأشياء قد لا يقولها المعنى...، وقد ذكر الباحث كلاماً يكفي عند قراءته فهم هذه العلاقة ويغني عن الرجوع إلى غيره في فهمها إذ يقول: فالشعر ليس مجرد إشارة لغوية، بل هو أكثر من ذلك، إنه حياة وتجسيد لحياة عميقة وكثيفة فهو لا يقر الحقائق ولكنه يصورها وهو لا يخبرك بها، ولكنه يدفعك بها وينيرك من الداخل كي تنشط إلى حياة أفضل وعالم أسعد ولا يستطيع الشعر أن يحقق هذه الوظيفة إلا بهذا التنظيم غير العادي للأصوات - أي الإيقاع - فالإيقاع وحده هو الذي يستطيع أن يحمل المشاعر والأفكار العميقة المتميزة والصادقة لأنه إشارة طبيعية إلى عمق الانفعال. ومتى تكلم المرء شعراً فكأنه بذلك وحده يقول: إن ألمي أو فرحي هو من القوة بحيث لا يمكن أن أعبر عنه باللغة العادية وكأني بإيقاع الشعر ضربات القلب تسمعها الأذن وتنظم الصوت فإذا سمعها الآخرون أخذت قلوبهم تخفق هي الأخرى على هذا الإيقاع عينه.
وكانت العلاقة بين نمط معين من الإيقاع وبين أغراض الشعر - العواطف الإنسانية - قد بدأت بأرسطو كأول محاولة من هذا النوع - كما ذكر الباحث-.
كما تناولها بالذكر أيضاً ابن سينا وابن رشد، ثم تطورت القضية فرأى آخرون - في العصر الحديث - أن الربط ينبغي أن يكون بين الوزن والعاطفة كالدكتور إبراهيم أنيس، ولم ينتهِ الأمر عند هذا، حيث عدل هذا الاتجاه من قبل الدكتور محمد النويهي فرأى أن الربط يكون أحرى بين الوزن ودرجة العاطفة إذاً.. فالإيقاع حركة المعنى وليس ثم بينهما انفصال ولإدراك أحدهما ينبغي اكتشاف الآخر معه.
ولقد لفت انتباهي عدة قضايا تعرض لها الباحث في الفصل الأول من كتابه، حيث تعرض لقضية الخروج على الشكل الموسيقى التقليدي عند شعراء أبو للو، وذكر أن هذه المحاولات للخروج من الوزن الواحد والقافية الموحدة كان منذ القدم، فأشار إلى أن أبو العتاهية والمولدين قد اخترعوا أوزاناً جديدةً كما أن الأندلسيين استطاعوا بموشحاتهم أن يخرجوا على الشكل التقليدي. فكل هذه المحاولات وغيرها كان لها - بالتأكيد - تأثير على شعراء أبو للو، أصحاب الاتجاه الوجداني العاطفي.
غير أنه لفت انتباهي الحديث عن قصيدة عبيد بن الأبرص (أقفر من أهله محلوب) حيث ذكر أنها كانت محاولة للتحرر من إطار الوزن الواحد، وذكر أنها وصلت إلى درجة الشعر الحر. كما لفت انتباهي أيضاً في ص(40) هذه العبارة المقتبسة من قبل الباحث (الموسيقى ليست الوزن السليم وإنما الموسيقى الحقة هي موسيقى العواطف والخواطر تلك التي تتواءم مع موضوع الشعر وتتكيف معه، أو كما يقول حسين عفيفي الذي اشتهر بخروجه تماماً على موسيقى الشعر إلى الشعر المنثور: الإيقاع وحده، هو السبيل الذي يستمد منه الشاعر معناه. وفي المقابل نجد رأياً آخر للدكتور محمد خفاجي في كتابه (الشعر الجاهلي) إذ يقول في ص(189) وأهم العناصر التي تفرد الشعر بطابعه الخاص وتضفي عليه سمة معينة هو الوزن فإن لحسن الإيقاع، وجمال التقسيم وروعة التنغيم، من الخفة على السمع العلوق في القلب، والتأثير في النفس ما ليس للكلام المسرور، الذي لا يسنده الوزن، ولا يؤلف بينه النظام، وفي موضع آخر يقول: ولا يخفى ما للقافية كذلك من سحر وجاذبية ومن جمال ووقع لدى السمع، ومن دلالة على براعة الشاعر، وإعلان عن مقدرته.
وقد استشهد الشاعر في إحدى قضاياه بقصيدة رائعة لإبراهيم ناجي الميت الحي، والأروع منها براعة الباحث ونفاذ بصيرته إلى المشاعر والأحاسيس المكنونة في قلب هذا الشاعر الحساس حيث إنه استطاع من خلال التحليل الإيقاعي للقصيدة أن يكشف لنا وبشكل دقيق عن كوامن الشاعر الشعورية ولهفته وضياعه وتحسره وأمله.... إذاً فإني أعتقد في أن التركيز أو محاولة فهم إيحاءات الأدوات الفنية التي يستخدمها الشاعر للتعبير عن تجربته هي المفتاح الأول في فهم هذه التجربة والتعايش معها، ورأينا أن الشكل القديم ليس مانعاً أو حاجزاً لدى الشاعر في التعبير عن تجربته الشعورية خير تعبير، فإبراهيم ناجي - كما يقول الباحث - استطاع أن يحقق من خلال الأوزان العروضية قصائد جديدة كما في قصيدته هذه (الميت الحي) التي وإن التزمت النسق العروضي، إلا أنها استطاعت به ومن خلاله أن تحقق تشكيلاً جيداً واضح الفنية. (فجددوا في مضامين وأفكار)، ومن خلال إحصائيات الباحث وجد أن نسبة استخدام شعراء أبو للو للقافية الموحدة مرتفعة جداً بلغت 80% من إجمالي أشعارهم، وبلغت نسبة التنويع 20% فقط. إذاً فشعراء أبو للو لم يهجروا الشكل القديم بل كتبوا فيه النسبة الغالية من أشعارهم وقدموا أشكالاً جديدةً في القليل من هذه الأشعار، والثبات ليس دائماً جموداً وركوداً وإنما هو في الوقت ذاته في بعض جوانبه عرافة وأصالة، وقد استفاد شعراء أبو للو من إمكانيات التنويع في القافية والضرب من خلال الأشكال الشعرية المنوعة الإيقاع كالمربع والمسمط والمزدوج في التعبير عن تجاربهم الشعرية تجاه ما يعتريهم، ويمس قيثارة أحلامهم وأشواقهم.
والملاحظ أنه لا يوجد فن بلا قيود تُذكر إذاً فمن الظلم أن يُوصف الشعر العربي القديم بالجمود والتخلف - وقد نظم عليه أصحاب هذا الاتجاه -، وأنه كالأغلال المقيدة لعواطف الشاعر عن الانطلاق والغنائية الحرة، نعم لقد مر الشعر العربي بمراحل جمود حيث كان بعض الشعراء ينظمون لمجرد النظم، لا لإعطاء تجربة شعرية عميقة تعبر عمَّا يختلجه الشاعر من مشاعر تترى، ولكن سرعان ما عاد إلى سابق عهده على يد رب السيف والقلم، فبث في حناياه الحياة والحركة، وسار على نهجه الشعراء من بعده، كما أن الفنون الأخرى المستحدثة بل أضرب الشعر الأخرى سواء أكانت القديمة أو الحديثة، وإن كانت أكثر حرية - بالنسبة للشاعر - إلا أنها هي الأخرى تتقيد بقيود لا حرية مفتوحة مطلقة كالموشح مثلاً، وكذلك شعر التفعيلة الذي أصبح فناً له قواعد وأصول لا بد من اتباعها كي يكون النتاج أكثر عذوبة وشفافية لا غموض وانغلاقية.
والخلاصة.... نجد أن شعراء أبو للو - شعراء القلق الاجتماعي - قد أخذوا بقول عبدالرحمن شكري:
ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان
في تطوير الشعر العربي الحديث من خلال ربطه بالوجدان الإنسان، فهاموا عذاباً وشقاءً، وغردوا عالياً في أفق بعيدة طابعها السكون الحزين، والأسى العميق. وهكذا هم الشعراء أصحاب القلوب المرهفة في كل زمان ومكان.
إذاً فالتجديد مطلوب ومرغوب في الشعر العربي على مر عصوره كي يكسر ملالة السير على وتيرة واحدة، والجمود تحت تقاليد لا تسمح له بالتطور، كما حدث في العصر الجاهلي حينما شكا أحد الشعراء الفحول زهير بن أبي سلمى في قوله:
ما أرانا نقول إلا معاراً أو معاداً من قوتنا مكرورا
من تكرار المعاني والألفاظ والأحداث في الشعر الجاهلي، حيث أصبح من الملالة الاستمرار في ذلك، ولكي يحافظ الشعر الجاهلي على روعته وخصوبة خياله لا بد له من التجديد. وبظهور الإسلام تحقق له المراد بذلك، فامتاز الشعر العربي في ظل الدولة الإسلامية بالجدة، فهذب وطور فتغير مضمونه بدرجة 80% حيث حرر الفرد من المادية إلى الروحية الرحبة السامية.
وفي النهاية... وجدت أن الباحث قد اعتمد على الكثير من الكتب القيمة وقد أحسست بقيمتها من خلال إشارات الباحث لها في هوامش كتابه، واقتباساته منها ما يكمل ويعضد القضايا العديدة التي تناولها في كتابه، ولكني رأيت أهمها - باعتقادي - كتاب موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس، الذي اعتمد عليه كثيراً.
|
|
|
| |
|